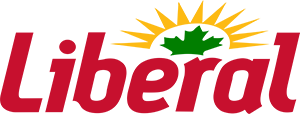رستم محمود: قليلة هي التجارب العالمية الشبيهة بالحالة السورية
قليلة هي التجارب العالمية الشبيهة بالحالة السورية، بالذات تلك التي لدول مركبة من جماعات أهلية وأثنية متعددة مثل سوريا: فطوال عقد كامل، كان هذا الكيان مركز الفعل الأكثر حيوية على مستوى العالم، حتى امتدت تأثيراته لتمس وتغير أشياء كثيرة في مختلف أرجاء العالم. لكن، وفي نفس الوقت، بقيت قواه السياسية الرئيسية، أو بالأحرى القوى السياسية الممثلة والمعبرة عن الكتلة والجماعة الأهلية “الوطنية” الرئيسية داخله، في حالة تلعثم و”خِرس” سياسي استثنائية، من حيث فقدان كامل القابلية على الإجماع والطرح والمبادرة. وكأن كل هذه الأحداث المهولة داخلها لا تعنيها!!.
بحكم التاريخ والديموغرافيا والتوزع الجغرافي، يشغل “العرب السُنة” تلك المساحة في سوريا. إذ كانت قواهم ونُخبهم السياسية تعرض نفسها تاريخياً، وما تزال، كمتنٍ وحمال للـ”الهوية الوطنية”. بقول أكثر دقة ومباشرة، كان أبناء هذا التشكيل الأهلي السوري يعتبرون أنفسهم “الشعب”، بينما يصنفون باقي التشكيلات الأهلية السورية باعتبارها “أقليات”.
ليس الأمر مجرد مشاعر جمعية ونسبٍ ديموغرافية، بل يمتد لأن يكون شيئاً دستورياً وقانونياً. فالهيكل الجوهري للدولة السورية ذا تعريف وهوية “عربية سُنية” بوضوح تام. الدستور يقول ذلك بأكثر من معنى وأداة تعبير، كذلك باقي المواثيق والتعبيرات الرمزية لمؤسسات وآلية عمل هذه الدولة تكرس ذلك. يمكن ملاحظة ذلك مثلاً في القضاء والتعليم والمناسبات الرسمية والإعلام والخطاب العمومي.
لكن، كيف لهذه الجماعة التي تحتل كل هذه المساحة، أو للقوى السياسية التي تعتبر نفسها ممثلة للجماعة الشاغلة لهذا المتن الوطني، وفي ظلال هذه الفظاعة المتناهية التي صارت تمحق كل أسباب الحياة في هذا البلد، كيف لها أن تستنكف عن قول أي شيء سياسي وخطابي وثقافي ذو مضمون ومعنى وقيمة، موازٍ من حيث جذريته وحيويته لمستوى جذرية ما يحدث.
في هذا العقد المرير مثلاً، عشرة بالمائة من سكان هذا البلد، على الأقل، كانوا ضحايا مباشرين للحرب الأهلية هذه. ونصف السكان، أيضاً على الأقل، اقتلعوا من بيئاتهم المحلية وهُجروا. دُمرت العديد من المدن والبلدات، وصارت كل البلاد تقريباً فاقدة للقابلية للحياة. ومع كل ذلك، بقيت التعبيرات والقوى السياسية الممثلة لهذه الكتل السكانية تقول عبارات بائسة وباردة عن “الوحدة الوطنية” و”المساواة في المواطنة” و”الدولة المدنية” و”الديمقراطية”. مع بعثرة تنظيمية وصراعات داخلية شخصية وسلوكيات صبيانية متناهية الرداءة، إلى جانب شبكة هائلة من الارتباطات والولاءات والعلاقات الاستخباراتية مع كامل الدول الإقليمية، وانحدار فكري وممارسة لمختلف أشكال وأنواع الفساد المتخيلة.
أي، أن خطاب وطروحات القوى السياسية الممثلة لهذه البنية السكانية، تبدو غير قادرة على وعي ما يجري، وخلق آليات خطاب وفعل سياسي موازية ومناسبة له، قادرة على الإحاطة والمبادرة والطرح، تجترح إمكانية ما لتفكيك هذه المأساة وحظوظ ما لتجاوزها.
في ظلال هذا التموضع، يبدو أن التفسيرات المبسطة والمباشرة غير قادرة على تفكيك وفهم هذا التعارض الجوهراني.
فلا الطبيعة الشمولية المديدة للنظام الحاكم تفسر ذلك، فالكثير من قوى المعارضة في العالم، وحتى الإقليمية القريبة من سوريا منها، عاشت نفس الظرف الشمولي، لكنها أظهرت مستويات من الوحدة الداخلية والقابلية للطرح تتجاوز رداءة المعارضة السورية بأشواط. ولا مستوى العنف المهول الذي مورس على السوريين يشرح ذلك، لا التاريخ الإيديولوجي للتنظيمات السورية ولا العلاقات الإقليمية. فهذه كلها تفسيرات جزئية وموضعية، مناسبة وقابلة لفهم بعض الزوايا من المسألة وفي حالة بعض التنظيمات فحسب. أما فيما خص هذه الظاهرة بكلانيتها، فثمة ما يتجاوز هذه المعطيات التفصيلية.
ثمة ما يتعلق بسوريا نفسها، ككيان وبنية دولتية مفترضة، دون أن تكون كذلك بالضبط. سوريا التي تفتقد كل الأسس والديناميكيات الداخلية التي تختزنها وتعمل الكيانات “العادية” حسبها تقليدياً. الكيانات “العادية” التي تتفجر داخلها فاعليات موازية ومناسبة للأحداث العمومية التي تجتاحها بين وقت وآخر.
فسوريا هذه، لا تاريخ كياني لها مثلاً، لم يكن في التاريخ من دولة بهذا الاسم والجغرافيا، كما كانت مصر أو المغرب أو إيران مثلاً. ولم يكن ثمة حتى شيء قريب منها، كما كانت “متصرفية جبل لبنان” بالنسبة للبنان.
وسوريا هذه ليس بين مناطقها وجهاتها المبعثرة أية “سردية وطنية” مشتركة، حتى ما سمي “النضال ضد المستعمر الفرنسي” كان حكاية مختلقة، ما صدقها أحد منهم. وسوريا هذه لم تفرز يوماً أحزاباً وقوى سياسية وتنظيمات مدنية سورية الكيانات، فكل ما أنتجته من أحزاب كانت متجاوزة لها وتريد محقها، حتى تلك التنظيمات التي كانت في “الزمن البرجوازي”، كانت منقسمة بين العراق ومصر والعربية السعودية.
وسوريا هذه ليس بها أية شيفرات ثقافية واجتماعية ذات قيمة مشتركة لدى غالبية واضحة منهم، لم ينتج السوريون أغنية واحدة عما هو مفترض “بلادهم”، والأغنية الوحيدة التي في البال في ذلك السياق “سوريا يا حبيبتي” كانت من منتجات حزب البعث، الذي احترم ووالى كل شيء أكثر من سوريا. ولا يكاد يتفق السوريون على شخصية عامة واحدة قط، بما في ذلك رموز الكوميديا التلفزيونية.
ليست تلك التعينات مجرد أحكام عمومية عن كيان وكتلة من السكان ضمنها، بل هي مجموعة من الخصائص التي لها تأثير مباشر ودائم في الوقائع على الأرض. إذ لولاها، كيف يمكن تفسير أن هذا البلد كان قابلاً لأكبر عدد من الانقلابات العسكرية، ومن ثم كان بلداً قادراً على التخلي عن هويته وسيادته والاندماج في بلد آخر، وبعد الأمرين حكمته عائلة ومجموعة من الفروع الأمنية، لم يعارضهم أحد، خلا بعض المثقفين. وكيف يمكن تفسير أن سكانها حينما ثاروا، لم يثوروا كشعب، بل كانتفاضات محلية مبعثرة، لا روابط ولا رؤية مشتركة فيما بينها. حتى حينما كان ينفذ هذا النظام مجازر بحق منطقة أو أخرى من هذا البلد، فإن السكان الأقربين لمنطقة الجريمة، وحدهم كانوا يتفاعلون ويندبون أحوالهم المريعة، بينما كان الآخرون يتابعون حيواتهم الرتيبة وكأنه ليس من شيء قد حدث.
هل من دلالة على طبيعة وهوية هذا البلد أكثر من معاينة الحفلات الصاخبة التي كانت في بعض أحياء العاصمة دمشق، بينما كانت أحياء أخرى في الليلة السابقة قد تعرضت لقصف بالأسلحة الكيماوية!.
ليس كل ذلك بشيء حيادي. إذ كيف لمجموعة من النُخب والقوى السياسية التي تدعي تمثيلها للـ”الوطنية” أن تقول وتنتج وتفزر شيئاً ما ذا قيمة ومعنى وتأثير عن هذه “الوطنية”، في الوقت الذي ثمة شك كبير للغاية حول وجود هذا “الوطن” بذاته. الوطن باعتباره كياناً رمزياً وسياسياً وثقافياً واحداً، يتجاوز ما هو بعض الجغرافيا المحمية بالأسلاك الشائكة.
مقال راي- رستم محمود- نورث برس