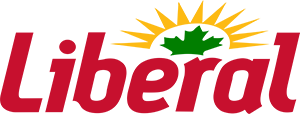كما جرت العادة كل سنة وفي شهر آذار، وبمناسبة انتفاضة السوريين ضد نظام الاستبداد والفساد، وفي سبيل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية أكرّس مقالة او أكثر لإلقاء الضوء على مسار الحدث وتعرجاته ومآلاته.
في هذا العام تدخل ذكرى الانتفاضة عامها الثالث عشر، في ظروف تغيرت كثيراً. ونظرا لتعدد قراءتها، كل بحسب موقعه السياسي والأيديولوجي، ورهاناته الخاصة، أو تلك المطلوبة منه، تملي الاعتبارات المنهجية لإنتاج معرفة صحيحة بها إعادة النظر في جملة من المفاهيم، وزوايا النظر التي استخدمت في قراءتها. نحسب القيام بذلك ضرورياً قبل البدء بتفحص مسارها، بكل تعرجاته، والعوامل والقوى التي رسمت هذه التعرجات، والتي تحدد اليوم مآلها.
كثيرة هي الأوهام التي رافقت انتفاضة الشعب السوري في سبيل الحرية والديمقراطية، بعضها سقط واقعياً، بحكم مسار الأحداث على الأرض، أو بحكم تغير مواقف أصحاب هذه الأوهام، أو مواقف أولئك الذين ساهموا في إنتاجها ودعمها من أصحاب الأجندات الخاصة في سورية. لكن هناك الكثير من الأوهام الأخرى، التي تعاند السقوط، وتمتلك قدرة عجائبية على التقمص، وإعادة التقمص بأشكال مختلفة لجوهر واحد، وهو أنها أوهام.
من هذه الأوهام التي تكاد تسيطر على الحقل السياسي المعارض في سوريا، وتتقدم الخطاب فيه، وهم وحدانية “تمثيل” الشعب. يكاد كل من يعمل في الحقل السياسي، يزعم أنه يمثل الشعب السوري، ويقدم نفسه بالتالي كناطق باسمه. لقد صار مفهوم “الشعب” مُضلِلاً بالطريقة التي يستخدم بها، وقد بلغ حجم الضلال في استخدامه درجة عالية، بحيث صار مفهوماً غير معين، يخضع لمزاج مستخدمه، يضع له الدلالة التي يريدها. مفهوم “الشعب” في اللغة، وفي الاصطلاح، هو مفهوم مركب لا يقبل التماثل الداخلي، لذلك لكي يتم استخدامه بصورة صحيحة ينبغي أن يُسبق بما يجزئه، كأن يقال “بعض” الشعب، أو “أغلب” الشعب، بحسب الحالة المستهدفة من الخطاب.
بالطبع يمكن تفهم الاستخدام المجازي لمفهوم “الشعب”، في الحالات التي يعبر فيها جزء منه عن مصالحه الكلية بصورة موضوعية، وليس بالمعنى المباشر. فالشعب بأغلبيته الساحقة، مثلاً، له مصلحة موضوعية في الحرية، وفي حكم القانون، وأن يكون رأيه مسموعاً في الشؤون التي تخصه، حتى ولو طالب بذلك جزء منه، أو ثار في سبيله.
ومن الأوهام التي تتحكم بالخطاب السياسي المعارض ولا تزال تعاند السقوط، القول بأن ما يجري في سورية هو “ثورة”. الثورة بالمعنى الاجتماعي، كما قدمها لنا التاريخ، وكما هي في التعميم النظري لتجارب التاريخ الثورية، لا تكون بدون توافر شروط ثورية، وفي مقدمتها توافر الشرط الذاتي في صيغة رؤية سياسية، وبرنامج لتحقيقها، وقيادة ثورية لها، وجميع هذه العناصر لم تكن للأسف متوافرة في الانتفاضة السورية. ما حصل في سورية هو نوع من التمرد المجتمعي، الذي تحول لاحقاً من خلال المظاهرات السلمية إلى انتفاضة ذات سمات شعبية، وكان من المحتمل أن تتحول إلى ثورة لولا الانتقال إلى العسكرة، وسيطرة المجموعات الإرهابية عليها التي حولتها إلى أزمة معقدة جداً.
لكن، هنا أيضاً يمكن استخدام مصطلح “ثورة” بالمعنى المجازي للدلالة على أن ما يجري في سوريا قد أخرج جميع الأسئلة المتعلقة بنظام الاستبداد، بل بالنظام الاستبدادي المشرقي ككل، من إدراج التاريخ، باحثاً لها عن أجوبة، لذلك أسميها بهذا المعنى “ثورة أسئلة” أو ثورة تطوّرية محتملة.
ومن الأوهام التي سيطرت على الخطاب السياسي المعارض وهم “إسقاط” النظام. كثيرون ممن نادوا بإسقاط النظام لم يطرحوا على أنفسهم كيف يمكن تحقيق ذلك؟، ولم يفرقوا بين النظام والمستوى الأول في السلطة، أي أشخاصها الطبيعيون، ولم يفرقوا بين الوظيفة التعبوية للمصطلح عندما يرفع كشعار في الشارع، وبين كونه مطلبا سياسياً مباشراً. بكلام آخر، لا يفرقون بين إسقاط النظام كعملية، وبين إسقاطه كحدث مباشر.
إسقاط النظام ليس حدثاً بل عملية، وهو لا يسقط بسقوط أشخاص الحكم، لأن الاستبداد ليس موجوداً فقط في الحقل السياسي، بل هو في العلاقات الاجتماعية، وفي الحياة الاقتصادية، وفي منظومة القيم العامة، وفي آليات التفكير، وفي جميع مناحي الحياة الاجتماعية الأخرى، تصونه، وترعاه، وتعيد إنتاجه، ثقافة استبدادية سائدة، وإن إزالته من هذه الحقول يحتاج إلى زمن، قد يمتد إلى عقود من السنين.
كثيرة أيضاً الرؤى الفكرية والسياسية الخاطئة للأزمة السورية نتيجة لاستخدام مقاربات منهجية خاطئة نعرض بعضها في الملاحظات الاتية:
الملاحظة الأولى؛ إن ما سمي بـ “ثورات” الربيع العربي، كانت في الجوهر تعبير عن ضرورات تاريخية لتفجر أزمات الاستبداد المزمن وتعويم أسئلته، التي أجابت عنها الشعوب العربية كل بحسب ظروفه الخاصة، وبحسب كثافة تدخل الخارج فيها.
الملاحظة الثانية؛ إذا كانت ظاهرة التمرد المجتمعي في سوريا، التي تحولت إلى انتفاضات شعبية في أشهرها الأولى، لا ترقى إلى مستوى مفهوم “الثورة” بالمعنى البنيوي (نقض الاستبداد بمعناه الشامل)، فهي مع ذلك ارتقت إلى مستوى “الأزمة” بالمعنى الغرامشي، يحكمها صراع بين شكلين للاستبداد أحدهما يدعي العلمانية، وآخر يطمح لبناء نظام إسلامي على “منهاج” النبوة، فكانت داعش والنصرة وأخواتهما.
الملاحظة الثالثة؛ لقد كشفت الأزمة السورية هشاشة البناء الاجتماعي والسياسي للدولة السورية، إذ أن الهويات الصغرى الطائفية والمذهبية والقبلية والعشائرية وحتى الهويات الضيقة ذات الطابع الثقافي والسياسي للنخب وأشخاصها هي الهويات الحقيقية الفاعلة، وما عداها لا يعدو كونه مجرد هويات متخيلة (قل أيديولوجية).
الملاحظة الرابعة؛ تتنافس على المجال الحيوي السوري ثلاث مشاريع إقليمية هي: المشروع التركي والمشروع الإسرائيلي والمشروع الإيراني ولكل منها أهدافه الخاصة. فتركيا سعت من وراء تدخلها الكثيف في الأزمة السورية إلى تكوين مجال حيوي لها بفضاء إسلامي، وقد عاونتها في ذلك قطر. اما بالنسبة لإيران فهي تحسب سوريا أساسا من مجالها الحيوي الاستراتيجي في المنطقة. أما بخصوص إسرائيل فكان هدفها المركزي هو تدمير الدولة السورية، والقضاء على الدور السوري التاريخي في إقليمها العربي، وليس إسقاط النظام.
لقد أدى التنافس (الصراع) بين هذه القوى الإقليمية (التي وجدت دعما دولياً) إلى تدمير الدولة السورية باستخدام حوامل سورية للأسف.