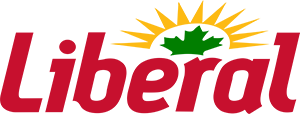التنوّع الهويّاتي ومشكلة الأجندة السياسية في العراق
الذاكرةُ التاريخيةُ والهويّة أداةٌ مهمّة بيد النخب السياسية لِتعزيز سيطرتها وشرعيتها. يقول إريك دافيس، في كتابه مذكّرات دولة إنَّ لِلدولة أنْ تفرض حكمَها بنحوٍ أوسع إذا ما أقنعت الجماهير بالخضوع لرؤيتها حول المجتمع. ولذا قد يُعرَض سؤالٌ في هذا الصدد يستفهم عن كيفية إدارة النظام السياسي العراقيّ بعد 2003 لمسألة التنوّع والهويّة الوطنية؟
لعلَّ الفكرة الأهم التي تبرز عند الحديث عن موضوع التنوّع والتعددية في أيّ بلدٍ ومجتمع، تتبلور في الرأي القائل بأنَّ “التنوّع عامل قوّة في المجتمعات”. فالتنوّع -بحسب الإعلان العالمَي لِلتنوّع الثقافي- “يشكّل قوّةً محرّكة لِلتنمية، ليس على مستوى النموّ الاقتصادي فحسب، بل أيضاً كوسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية وروحية أكثر اكتمالاً. ومن هنا يُعدّ التنوع الثقافيّ ميزة ضرورية لِلحَدّ من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة”.
إذا كان التنوّع عامل قوّة ويشكّل قوّةً محرّكة لِلتنمية فلماذا لم نلمس مثل هذه النتائج في العراق بعد 2003 رغم تميّز مجتمعه بالتنوع؟
ثمّة آراء مختلفة حول إشكالية الهويّة في العراق، فهناك مَن يعدّها إشكالية بنيويّة ظهرت مع تأسيس الدَّولة العراقية، ويعدّها آخرون إشكاليّة مصطنعة ظهرت بعد الاحتلال الأميركي. إذا اتفقنا مع الاتجاه الأوّل فيجب ألّا نغفل ملامح الهويّة الاجتماعية لِمَن كان يقطن في العراق عشيّة تفكك الدولة العثمانية، لاسيّما إذا عرفنا أنَّ تفكك الدولة العثمانية –بحسب ما يقول برهان غليون- قد “فَجَّرَ إحدى أعظم أزمات الهويّة التي عرفها الوطنُ العربيّ في تاريخه كلّه وأكثرها حدّة وديمومة”. ولا ريب أنَّ المجتمع العراقيّ لم يكن بمنأى عن هذه الأزمة، فإنّه تشكّل منذ تأسيس الدولة العراقية في بداية القرن الماضي، والدولة العراقية هذه كانت نتاجاً للهيمنة الكولونيالية التي سادت في ذلك العهد، وأنّها نتاج تشكيل نخب سياسية غير منسجمة حاولت بناء العراق وتحديثه.
مرّت الهويّةُ العراقيّةُ بمراحل تاريخية عدّة ذكرها باحثون في موضوع الهوية والذاكرة العراقية، إذ عبّروا عن المرحلة الأولى بجيل السقوط: (عشية انهيار الدولة العثمانية والاحتلال البريطاني)، ومرحلة الحكم المَلَكي، ومرحلة الحكم الجمهوري، (الجمهورية الأولى 1958-1963)، والجمهورية الثانية (1963-1968)، والجمهورية الثالثة (1968-1979)، والجمهورية الرابعة (1979-2003).
ورث النظامُ العراقيّ بعد 2003 معظم الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة، أهمّها المحاصصة والطائفية، والمبالغة بالاعتقاد بأنَّ المجتمع العراقي يتكوّن من ثلاث مجموعات متجانسة، (الشيعة والسنة والكرد). وهذه التراكمات تركت أثراً ملحوظاً على الذاكرة والهويّة وإدارة التنوّع على مستوى المكوّنات الاجتماعية الرئيسة والفرعيّة بعد 2003. فبعد أن كانت السلطةُ السياسية في الجمهورية الرابعة صانعة لِلهويّة لأغراض الحفاظ على السلطة، أضحت القوى السياسية بعد 2003 متصديّة لِعملية صناعة الهوية، فكلّ مُطّلع على مجمل الواقع الاجتماعي العراقي بإمكانه أن يشهد ظاهرة التدين الشعبي وأثرها على وعي فئة كبيرة مِن المواطنين في اتخاذ القرار واختيار الولاءات السياسية. إنَّ القوى الدينية الشعبية التي تعاظم دَورُها في الحياة الاجتماعية والسياسية بعد 2003 باتت بحضورها المكثَّف تتحكّم بحياة بعض الأفراد وسلوكهم، حتّى أخذت قيم المجتمع المدنية بالتراجع، بعد إضعاف الطبقة الوسطى منذ بداية التسعينيات مع بداية ما سُميَّ بالحملة الإيمانية التي تبنّاها صدّام حسين. وقد اتسم جزءٌ كبير من الهوية العراقية بصفات بعد عام 2003 متأثرةً بخطاب أحزاب السلطة، لعلَّ أهمها “الطائفية”، إذ بات التفكير في الإطار الطائفيّ الضيّق سمة بارزة في بين فئات غير قليلة من العراقيين، و”محاصصة السلطة” إذ بدأت في فترة متقدّمة في تاريخ العراق المعاصر، ولكنّها ترسخت بعد 2003 حتّى أصبحت سمة بارزة في الأوساط السياسية والمؤسسات الحكومية؛ ومن ثمَّ “التطرف الديني والانغلاق على الآخر”، وهي نتيجة بديهية لِلخطاب الطائفي الذي وظّفته الأحزاب السياسية. ومن هنا وجدت التنظيمات الإرهابية بيئةً اجتماعية خصبة لِترويج التطرف والعنف ضدّ المكونات الأخرى. ولا يخفى أنَّ ضعف المنظومة التعليمية وتراجعها بسبب إخفاقات النظام السياسي كان له الدَور الأكبر في تراجع الوعي المجتمعي وصعود هويّة منغلقة على الآخر.
ويجب ألا ننسى أنّ صناعة الهوية بعد 2003 لم تقتصر على الأحزاب السياسية، بل العشيرة أيضاً أدّت دَوراً بارزاً في هذه العمليّة. فبعد أن كان النظام السياسي قبل 2003 يعنى بإحياء القوانين والأعراف العشائرية، وأضفى على العشيرة دَوراً سلبياً في المجتمع، استمرّ النظام بعد 2003 بهذه الطريقة لأغراض سياسية أهمها الفوز في الانتخابات، وبات لِشيخ العشيرة سطوة على وعي الفرد، ومن ثمَّ اتسمت هوية فئة كبيرة من العراقيين بالانتماء العشائري، وأمسى مثل هؤلاء متأثرين بما يمليه عليهم شيخ العشيرة المرتبط بالسلطة المتهمة بالفساد والطائفية. وبهذا شكّلت علاقة التصادم والتخادم بين الدولة والمشايخ واحدة من أهم السمات السياسية للمجتمع العراقي.
الذاكرة التاريخية – كما أسلفنا- أداةٌ مهمّة بيد النخب السياسية لِتعزيز سيطرتها وشرعيتها، فلطالما كانت الأنظمةُ السياسية المتعاقبة في العراق تسعى إلى التحكم بهويّة الفرد، واتضح ذلك بصورة جليّة بعد 2003 على يد الأحزاب التي خلقت عقلاً جمعياً يتسم بالطائفية والعنف. وعلى الرغم من أن التنوّع عامل قوّة نافعة لِلتنمية، فلم نلمس مثل هذه النتائج في العراق بعد 2003 رغم تميّز مجتمعه بالتنوع. ذلك أن الأطراف الفاعلة في صناعة الهوية والذاكرة عملت على تقويض هذا الدَور. فالخطاب الطائفيّ جعل غالبية العراقيّين -بحسب التجربة المعاشة لدى الكاتب- بلا هويةٍ سياسيّة، لاسيما في محافظات “الوسط والجنوب”، التي تندد بِكلّ مآلاتِ السلطة التي قادتها قوى سياسية دينية.
إنَّ الطائفيةَ –بوصفها سمة بارزة في الذاكرة والهويّة الراهنة- لا تسمح لِلتنوّع أن يؤدّي دَورَه الإيجابيّ. أمّا الحلول فهي موجودة في جُعبة الأحزاب العراقيّة، فإنّها اليوم بما تملكه من رصيد جماهيري ومن حصّة كبيرة في السلطة تستطيع إحياء مشروع بناء الهوية الوطنية الذي تبنّاه النظام الملكيّ فيما لو توفرت الإرادة الصادقة، وذلك من خلال إصلاح سلوكها وتجاوز الرؤى المؤدلَجة. لأنَّ الطائفيةَ التي أمست علامةً بارزةً في الذاكرة العراقية ليست نتيجة تعددية المجتمع، بل هي نتيجة تدخل السلطة سلباً في إدارة الجماهير لِصالح منافعها.
-الحرة-إياد العنبر