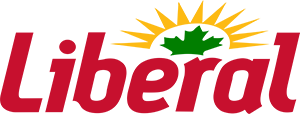النظر لتجربة الحريديم في إسرائيل من زاوية أخرى
أثناء جولات مناقشة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي المخضرم بنيامين نتنياهو زعماء طائفة “الحريديم” اليهودية بالسعي لبناء مدينة خاصة بهم، تُطبق فيها مجموعة من القوانين والتشريعات المدنية والجنائية والاقتصادية والرمزية الموافقة لعقائد أبناء هذه الطائفة، تكون كحل واستجابة لمطلب تقليدي لأبناء هذه الطائفة في إسرائيل، حيث يجد قادتهم الروحيون وزعمائهم السياسيون صعوبة ورفضاً للاندماج والقبول بالقوانين العمومية والتشريعات المدنية في إسرائيل.
الخطوة/التجربة المزمع القيام بها، ستكون أضافة إلى طيف واسع من التشريعات الخاصة التي أُقرت لصالح، وكان يتمتع بها، أبناء هذه الطائفة في مجالهم الخاص في إسرائيل: مثل تخصيص 3 بالمئة من سواحل إسرائيل لتكون خاصة بهم ومطابقة لفروض شرائعهم الدينية، وعدم إجبار أبنائهم على الانتساب للخدمة العسكرية الإجبارية، أو موافقة المحكمة الدستورية العليا في البلاد على بعض القوانين البلدية الخاصة بمشاريعهم العقارية ونشاطاتهم الاقتصادية، بما في ذلك الحق في العمل يوم السبت، وتقديم الدولة تمويلاً خاصاً لمدارسهم اللاهوتية.. الخ.
لا يبدو ذلك حلاً مثالياً بالنسبة لنوعية من النُخب الثقافية والسياسية المدنية، التي ترى وتعتقد أن الدولة بمؤسساتها ووثائقها وشرائعها يجب أن تكون مجردة وعمومية شرطاً، لا تمايز بين مجموعة من المواطنين وآخرين منهم، طبقاً لعقائدهم أو تبعاً لهوياتهم أو جماعاتهم الأهلية، القومية والدينية والمناطقية واللغوية. فالدولة في المحصلة، حسب هؤلاء، هي الجهاز التشريعي والوظيفي المتعالي عن أية تمايزات ثقافية أو عقائدية أو عرقية، تبني أواصرها مع أمة المواطنين حسب هويتهم المواطنية وبناء على تعاقد مدني معهم، قائم على مجموعة من الفروض والواجبات المدنية فحسب.
لكن، ومع كل الاعتبار لمثل تلك النزعات “المثالية”، إلا أن السؤال الذي يحضر بالمقابل مباشرة: لكن ماذا لو كان ثمة كتلة وتشكيل مجتمعي ما ضمن هذه الدول، مبني على نوعية من العقائد والنزعات الخاصة، التي لا تقبل اندماجاً تعتبره تفكيكاً لأواصر هوياتها الثقافية والعقائدية الخاصة، تخاف منه وتصنفه كمحاولة لتجريدها من خصوصياتها وما تصنفه كعالم داخلي لها، غير متعارض مع قيم العيش والسلام الاجتماعي مع الآخرين؟ خصوصاً، وإن هذا التشكيل الاجتماعي قد يكون شديد المركزية حول عقائده الخاصة تلك، وتالياً قابلاً للصِدام وتعكير الفضاء العام، في حال عدم الاعتبار والتقدير لما يقوم عليه ويعتقده، ولو بشكل نسبي.
بهذا المعنى، فإن مختلف دول منطقتنا، بالذات تلك التي تقوم مجتمعاتها على طيف من التشكيلات الدينية والعرقية والطائفية والمناطقية واللغوية الخاصة، تفوق هوية كل واحدة منها وانتماء أبنائها لتلك الهويات الأهلية، ما ينتمون به إلى الدولة وقيمها وفضائها المدني المجرد، المفترض، فإننا أمام واحد من حلين غير مثاليين:
أما القهرية/المدنية، إن جاز التعبير، كما في عدد من دول المنطقة. تلك الدول وأنظمتها الحاكمة، التي تستبطن في سلوكها الفعلي ووعيها الباطن كتلة كبرى من النزعات الطائفية والقومية والثقافية، التي تفرضها على الجماعات الأخرى، بدعوى المدنية والعلمانية وحق الدولة في فرض خيارها.
أي، فعل أشياء شبيهة بما تفرضه دولة مثل سورية في قوانينها وأنظمتها التعليمية والقضائية والتشريعية من خيارات وإيديولوجية إسلامية سُنية عروبية على باقي أبناء الطوائف والقوميات والأديان الأخرى في البلاد، منذ تأسيس الكيان وحتى الآن، وإن تحت يافطة مدنية الدولة وعمومية قوانينها وأفعال مؤسساتها. أو كما يجري من فرض لإسلامية شيعية نظيرة في العراق، أو عروبية إسلامية في مصر. فكل واحدة من هذه الكيانات، أنما تحتوي نواة صلبة ما، هي بالأساس جماعة أهلية بعينها، تطبق فعلياً رؤيتها وخيارها الطائفي والديني والعرقي، وتفرضه على الآخرين، وإن بلبوس التشريعات المدنية العمومية الدولتية.
ذلك الخيار الذي كشف، في أمثلة لا تُعد، أنه يؤدي فعلياً إلى اندلاع الحروب الأهلية، التي تأتي كنتيجة للحروب الأهلية الباردة، التي تتراكم طوال سنوات وعقود من فرض تلك العقائد المركزية على الآخرين، وإن بعناوين وشعارات مدينة.
الخيار الآخر، قائم على منح أبناء هذه التشكيلات الأهلية أعلى وأوسع مساحة من ممارسة ما يعتبرونه خياراتهم وثقافتهم وعقائدهم الخاصة في مجالات خاصة بهم، وإن برزمة كُبرى من الشروط والمحددات، التي تحفظ من جهة بعض الحقوق الأساسية للدولة، كجهاز وجهة حامية وحافظة للسلام الاجتماعي والاستقرار الدائم، ومن جهة أخرى حفظاً للحقوق الأساسية والعامة لأفراد هذه الجماعة نفسها. وطبعاً حماية للكل المجتمعي والدولتي مما قد تفعله هذه الجماعة في مجالها الخاص، والذي قد يعترض مع حريات وحقوق الآخرين.
فمثلاً، يمكن للدولة التي تعطي مثل هذه الجماعات تلك الحقوق، يمكن لها أن تفرض عليهم الإقرار بحق أي فرد منها بالخروج و”التحرر” من فروضها، وحماية أي منهم من العنف والإكراه، وإلزامهم بعدم انتهاج أية سلوكيات وعقائد تدعو للعنف والكراهية والنبذ، وقبولهم العمومي بحقوق الآخرين بممارسة عقائدهم ووظائفهم العمومية دون أي تمييز، وخضوع الكل للجهاز القضائي المدني في حال حدوث تعارض ما بين مجالهم الخاص والمجالات الأخرى.
لا ينبع القبول بمثل تلك النماذج وآلية الفعل السياسي من أية رغبة بزيادة مستويات وشرعنة انغلاق الجماعات الأهلية على ذواتها، لكنها محاولة للقول إن مختلف الثنائيات المغلقة التي تُعرض كحلول للمسائل الطائفية والعرقية والثقافية في بلداننا، التي تؤدي إلى واحدة من كارثتين، أما القهر أو الحروب الأهلية، آن لها أن تجرب أشياء أخرى، طالما أن السلام الاجتماعي والتعايش هو الهدف الأعلى والأسمى.
رستم محمود