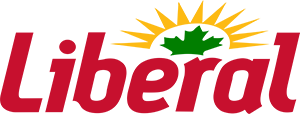مقاتل كردي في الخندق.. يقرأ أخبارا من السويد
رستم محمود
ليس من برلماني سويدي واحد، إلا ويعرف أن “التعديل الدستوري” الذي أقروه مؤخرا، شبه مُجمعين، والمسمى “تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب”، أنه لا يستهدف أي تنظيم أو جماعة “إرهابية”، كما يُدعى ويُحاول أن يُروج، إنما يتقصد المجتمع والأحزاب وكامل المشروع السياسي الكردي، في تركيا وسوريا وباقي بلدان المنطقة، قبولا وخضوعا للفروض التركية، التي تعتبر ذلك شرطا للموافقة على عضوية دولة السويد لحلف الناتو.
بهذا المعنى، فإن برلمان الدولة التي تعتبر نفسها معنية بشكل مباشر وتفصيلي في “المعركة العالمية في مواجهة التطرف والعنف”، إنما يقر ويكشف واحدا من أهم أوجه العلاقة الانتهازية لهذا “العالم الغربي” بالكتلة السكانية الشريكة في هذه “المعركة”، أي الأكراد: الذين هُم شركاء مُرحب بهم حينما يكونون مجرد كتلة من المقاتلين المنذورين للانخراط في أعتى المعارك وخسارة آلاف الضحايا، لكنهم بالمقابل، ككتلة سكانية وجغرافية وحقوقية وإنسانية، مجهزون للمقايضة والتخلي والبيع، لو كانت أصغر مصالح وحسابات ذلك “العالم الغربي” تقتضي ذلك. وحتى لو كان ذلك التخلي لصالح ووفق حسابات الدولة التي تُعتبر في الدفة الأخرى لمواجهة التطرف العالمي.
لا ينحصر منطق العلاقة هذه على دولة السويد فحسب، فغيرها الكثير، بما في ذلك أكثر دول المنظومة الغربية شكيمة، كانت مستعدة لأشياء من مثل تلك، وما تزال، وحسب نفس آلية التفكير والمنطق السياسي. الذي يتجاوز السياسة ليكون نوعا من البنية العقلية والمنطقية التحتية لهذه المنظومة العالمية. إذ ثمة على الدوام نوع وخاذ من البرغماتية الباردة، النابعة من شيء غير قليل من الشعور بالتفوق وعدم جدارة وأهمية الآخر، حتى لو كان “شريكاً”.
يقال ذلك، وفي البال حوادث ونماذج سياسية تاريخية تكاد لا تُحصى. حيث في كل واحدة منها، تعرضت المجتمعات والتنظيمات والحقوق السياسية الكردية إلى نكسة كُبرى، بعد أن تُخلص منها فجأة، من قِبل دول منظومة الأقوياء تلك.
بمستوى أعمق، لا يتعلق الأمر بالأكراد فحسب، حتى لا يُقال إنه ثمة مناهضة ثقافية أو عرقية غربية ما لهم كجماعة بذاتها، بل يتجاوزهم الأمر، ليكون نوعاً من الفاعلية الخاصة التي تمارسها دول هذه المنظومة مع طيف واسع من التكوينات العرقية والسياسية الأقل قابلية على حماية ذاتها، وعلى مستوى العالم. إذ تعاني جمعيا من ذلك النوع من المعاملة، عبر ثنائية الرعاية والشراكة وقت الحاجة، ومن ثم التخلي والنكران بعد حين، بناء على حسابات سياسية رياضية باردة محضة فحسب.
لهذه الآلية من المنطق السياسي الغربي أساس أولي، يعود إلى السنوات التأسيسية للكيانات الحديثة في منطقتنا، حينما كانت دول المنظومة الغربية/الإمبراطورية وقتئذ، قد خاضت نقاشاً سياسياً استراتيجياً خلال عقد كامل (1913-1923)، بشأن تركيب الكيانات الجديدة بعد عصر الإمبراطوريتين العثمانية والقاجارية.
وقتئذ، سقطت الجماعات الأهلية والعرقية من الحسابات تلك، وصارت دول تلك المنظومة تسعى لصناعة كيانات مركبة لكن مركزية، مملوكة ومحكومة من التكوينات الرئيسية التي كانت في تلكم الإمبراطوريتين الشرقيتين، وحسب ولاياتها ومراكز القوة داخلها.
حسب ذلك، سقطت جماعات أهلية كبرى، كالأرمن والسريان واليونان والأكراد والأمازيغ والأذر في مصيدة فروق العملة والمساومات داخل لعبة الأمم، وبقيت تدفع أثمانا باهظة داخل بلدانها جراء ذلك. في نفس الوقت الذي كانت دول المنظومة العالمية/الغربية ترعى تلك الدول وتمتن هياكلها الدولتية، التي كانت تقسر وتعنف ما بقي من هذه الجماعات الأهلية.
س من برلماني سويدي واحد، إلا ويعرف أن “التعديل الدستوري” الذي أقروه مؤخرا، شبه
لا يُقصد بالأمر رجم البنية السياسية لطريقة تعامل الغرب/المركز العالمي مع هذه الجماعات الأهلية، التي ينبع منها ذلك النوع من السلوك السياسي، بل الكشف والإشارة إلى نوعية من التناقضات الداخلية لتلك المنظومة الغربية، التي حاولت طمسها وتغيير ملامحها طوال تاريخ مديد من نشر وترويج أدلجة وخطاب مؤازرة الحرية والديمقراطية على مستوى العالم. من أن طرح الرئيس الأميركي، وودرو ويلسون، مبادئه الأربعة عشر قبل أكثر من قرنٍ من الآن، وحاولت آلة دعائية كبرى ما، أن توحي بأنها أنما “مبادئ الغرب” في علاقته مع مستضعفي العالم.
إذ لا قيمة سياسية وإيديولوجية وثقافية وإنسانية مضافة لهذه المنظومة العالمية الغربية/الديمقراطية، مقارنة حتى بالنزعات العالمية الأخرى، الروسية الصينية اليسارية والإسلامية. ففي المحصلة، تبدو خطابات مؤازرة الحرية ودعم الديمقراطية من قِبل هذا الهيكل الغربي مجرد أداة وظيفية، لا تعني شيئاً غالباً على أرض الواقع. فالحرية وحق الجماعات في تحديد مصيرها والنزوع نحو حماية المستضعفين غير مأخوذة في أية حسابات، التي غالباً ما تجري حسب آليات أخرى تماماً.
كذلك فإن الأمر يكشف المستوى الموضوعي لملف “مواجهة التطرف”، باعتباره مسألة أمنية وسياسية بالنسبة لهذه القوى الغربية، من دون أية علاقة بالجوانب الثقافية والوجدانية والروحية والأخلاقية لهذه المعضلة الكونية، النابعة بذاتها من جذور ثقافية وروحية وأخلاقية.
فالذين كانوا شركاء في مواجهة هذه المهمة، التي من المفترض أن تكون كونية الهوية وأخلاقية التكوين، أي الأكراد، تم تركهم لمصائرهم البائسة، يشبهون الجماعات والأمم التي انخرطت في مهام كونية نظيرة من قبل، في مواجهة النازية أو الإمبراطورية العثمانية، الذين واجهوا من قبل ما يجربه الأكراد راهنا. ففي كل مرة، ثمة شح كبير في مصداقية الشريك الأكبر، الذي يوحي وكأن تلك المعارك والمواجهة الكبرى كونية الهوية وأخلاقية المنشأ، ليحدث ما هو عكس ذلك تماما فيما بعد.
أخيرا، فإن مثل هذه السلوكيات، إنما على نوعية المفاضلة السياسية الكبرى لقوى المنظومة الغربية في السياسة العالمية. إذ ثمة نزوع واضح لمراضاة وتحقيق مصالح الدول والجماعات “القوية” على مستوى أقاليم العالم، تفضيلها واستحسان شراكتها، على حِساب أيا كان. حيث أن هذا النوع من المفاضلة، إنما هو منبع وجوهر الحركات السياسية والإيديولوجية المناهضة لهذا الغرب، من يسارية وإسلامية، مرورا بما يناظرها من أناركية وقومية فاشية.
- الحرة